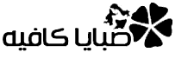من كتاب "القرآن كائن حي " -د/مصطفى محمود
... مــــن أنـــــت؟!؟ ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من أنت.. حينما تتردد لحظة بين الخير و الشر.. من تكون..؟!؟
أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم ما بينهما..؟!؟
أم تكون مجرد احتمال للفعل الذي لم يحدث بعد..؟!؟
...
إن النفس لا تظهر منزلتها و لا تبدو حقيقتها إلا لحظة أن تستقر على اختيار، و تمضي فيه باقتناع و عمد و إصرار، و تتمادى فيه و تخلد إليه و تستريح و تجد ذاتها.
و لهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولة، و لا ما يفعله الإنسان عن مرض أو عن جنون أو عن إكراه...
و إنما تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدها، لأن بلوغها الرشد يبدأ معه ظهور المرتكزات و المحاور التي ستنمو عليها الشخصية الثابتة.
و اختيارات الإنسان في خواتيم حياته هي أكثر ما يدل عليه، لأنه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح و تبلور جميع عناصر شخصيته، و تكون قد انتهت ذبذبتها إلى استقرار، و تكون بوصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد لهذه الشخصية.
و لهذا يقول أجدادنا.. العبرة بالخواتيم.. و ما يموت عليه العبد من أحوال، و أعمال و ما يشغله في أيامه الأخيرة هو ما سوف يبعث عليه.. تماما كما ينام النائم فيحلم بما استقر في باله من شواغل لحظة أن رقد لينام.
و لهذا أيضا لا تؤخذ النفس بما فعلته و ندمت عليه و رجعت عنه، و لا تؤخذ بما تورطت فيه ثم أنكرته و استنكرته، فإن الرجوع عن الفعل ينفي عن الفعل أصالته و جوهريته و يدرجه مع العوارض العارضة التي لا ثبات لها.
و قد أعطى الله الإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل و المراتب.. يختار منها علوا و سفلا ما يشاء.. أعطاه معراجا عجيبا يتحرك فيه صاعدا هابطا بلا حدود.. ففي الطرف الصاعد من هذا المعراج تلطف و ترق الطبائع، و تصفو المشارب و الأخلاق حتى تضاهي الأخلاق الإلهية في طرفها الأعلى ( و ذلك هو الجانب الروحي من تكوينه) و في الطرف الهابط تكثف و تغلظ الرغبات و الشهوات، و تتدنى الغرائز حتى تضاهي الحيوان في بهيميته، ثم الجماد في جموده و آليته و قصوره الذاتي.. ثم الشيطان في ظلمته و سلبيته ( و ذلك هو الجانب الجسدي الطيني من التكوين الإنساني).
و بين معراج الروح صعودا و منازل الجسد و الطين هبوطا، تتذبذب النفس منذ ولادتها، فتتسامى من هنا و تتردى هناك بين أفعال السمو و أفعال الانحطاط، ثم تستقر على شاكلتها و حقيقتها.
{ قل كل يعمل على شاكلته } ((84 – الإسراء))
و متى يبلغ الإنسان هذه المشاكلة و المضاهاة بين حقيقته و فعله فإنه يستقر و يتمادى، و يمضي في اقتناع و إصرار على خيره أو شره حتى يبلغ نهاية أجله.
و معنى هذا أن النفس الإنسانية أو ( الأنا ).. هي شيء غير الجسد.. و هي ليست شيئا معلوما بل هي سر و حقيقة مكنونة لا يجلوها إلا الابتلاء، و الاختبار بالمغريات.
و ما الجسد و الروح إلا الكون الفسيح الذي تتحرك فيه تلك النفس علواً و هبوطاً بحثاً عن المنزلة التي تشاكلها و تضاهيها و البرج الذي يناسب سكناها فتسكنه.. فمنا من يسكن برج النار ( الشهوات) و هو مازال في الدنيا، فلا يبرح هذا البرج حتى الممات، فتلك هي النفس التي تشاكل النار في سرها و هي التي سبق عليها القول و العلم بأنها من أهل النار.
و ذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحده، لأنه وحده الذي يعلم السر و أخفى، فهو بحكم علمه التام المحيط يعلم أن هذه الحقيقة المكنونة في الغيب التي اسمها فلان، و التي مازالت سرا مستترا لم يكشفه الابتلاء و الاختبار بعد، و التي لم تولد بعد و لم تنزل في الأرحام.. يعلم ربنا تبارك و تعالى بعلمه المحكم المحيط أن تلك النفس لن تقر و لن تستريح و لن تختار إلا كل ما هو ناري شهواني سلبي عدمي.. يعلم عنها ذلك و هي مازالت حقيقة مكنونة لا حيلة لها في العدم.
و هذا العلم الرباني ليس علم إلزام و لا علم قهر، بل هو علم حصر و إحاطة، فالله بهذا العلم لا يجبر نفسا على شر، و لا ينهى نفساً عن خير، فهو يعلم حقائق هذه الأنفس على ماهي عليه دون تدخل.
فإذا جاء ميقات الخلق ( و جميع هذه الأنفس تطلب من الله أن يخلقها و يرحمها بإيجادها و هي مازالت حقائق سالبة في العدم) أعطى الله تلك النفس اليد و القدم و اللسان لتضر و تنفع، و أعطاها ذلك الكون الفسيح الذي اسمه الروح و الجسد لتمرح فيه صاعدة هابطة تختار من منازله ما يشاكلها لتسكن فيه.. فإذا سكنت و استقرت، و تسجلت أعمالها قبضها الله إليه يوم البعث و الحساب المعلوم.. حيث تقرأ كل نفس كتابها، و تعلم منزلتها فلا يعود لأحد العذر في أن يحتج بعد ذلك حينما يضعه الله في مستقر الجنة أو مستقر النار الأبدية.
و قد أعذر الله و أنذر الجميع من قبل ذلك بالرسل و الكتب و الآيات، و أقام عليهم الحجة بما وهب لهم من عقل و ضمير و بصيرة و حواس تميز الضار من النافع و الخبيث من الطيب.
و لهذا حينما تطالب النفوس المجرمة في النار أن تعطى فرصة أخرى، و أن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات، و حينما يدعي البعض أن تعذيب تلك النفوس أبديا على ذنوب مؤقتة ارتكبتها في الزمن المحدود هو أمر ظالم.
حينئذ يجيب ربنا متحدثا عن هؤلاء المجرمين قائلا:
{ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذبون}(28 – الأنعام)
و في هذا الرد البليغ إشارة إلى أن إجرام تلك الأنفس لم يكن ذنباً موقوتاً في الزمن.. بل لأنهم ليعاودون هذا الجرم في كل زمن و مهما عاود الله خلقهم.. لأن ذلك الإجرام حقيقة مكنونة، و ليس عرضاً محدوداً بالزمان و المكان.. و لهذا كان عقابه الأبد، و ليس العذاب الموقوت.
و نقول أيضا: إن هناك عدالة عميقة كامنة في هذا المصير.. ناراً أبدية أم جنة.. إن كل نفس بينها و بين ذلك المصير النهائي مشاكلة تامة، و مضاهاة و ائتلاف في الحقائق.. فالحقائق النارية تسكن النار و الحقائق النورانية تسكن الجنة.. فلا قسوة هناك و لا وحشية، و إنما وضع لكل شيئ في مكانه.
و السر الآخر الذي ينكشف لنا أن البيئة لا يمكن أن تصنع من إنسان صالح ( نفسه صالحة بالحقيقة) إنساناً مجرماً و لا العكس، و أن الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلاناً لصاً، هذا الكلام لا يصدق دينياً و لا واقعياً. فالمجتمع يضع للجريمة إطارها فقط و لكن لا ينشئ جريمة في إنسان غير مجرم.. بمعنى أن لص هذا الزمان تعطيه إمكانيات العصر العلمية وسائل إلكترونية و أشعة ليزر ليفتح بها الخزائن، بينما نفس اللص منذ عشرين سنة لم يكن يجد إلا طفاشة.. كما أن قاتل اليوم يمكن أن يستخدم بندقية مزودة بتلسكوب ( كما فعل قاتل كنيدي) بينما هو في أيام قريش لا يجد إلا سيفاً، ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عصاً، ثم قبل ذلك على أيام قابيل و هابيل لا يجد إلا الحجارة.
إن المجتمع و العصر و الظروف تصنع للجريمة شكلها، و لكنها لا تنشئ مجرماً من عدم، و لا تصنع إنساناً صالحاً من نفس لا صلاح فيها.
و بالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتهما أن يقلبا الحقائق فيخلقا من ابنهما المجرم ابناً صالحاً و لا العكس.
و نجد في سورة الكهف حكاية عن غلام مجرم كافر، أبواه مؤمنان.
(( و أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً و كفراً )) (80 – الكهف)
و أكثر الأنبياء كانوا من آباء كفرة، و استجابت أكثر الأقوام لهؤلاء الأنبياء و لم يستجب الآباء.
من الذي يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس و يغيرها؟ لا أحد سوى الله وحده.
و الله لا يفعل ذلك إلا إذا طلبت النفس ذاتها أن تتغير و ابتهلت من أجل ذلك، لأنه واثقنا جميعا على الحرية التامة و على أنه لا إكراه في الدين.. و أن من شاء أن يكفر فليكفر، و من شاء أن يؤمن فليؤمن.. و أنه لن يقهر نفساً على غير هواها.. و أنه لن يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير و طلبت التغير.
(( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) (11 – الرعد)
و تلك هي التزكية.
(( و لولا فضل الله عليكم و رحمته ما زكا منكم من أحد أبداً و لكن الله يزكي من يشاء)) (21 – النور)
و على الإنسان أن يبدأ بتزكية نفسه و تطهيرها.
(( قد أفلح من زكاها، و قد خاب من دساها)) (9، 10 – الشمس)
(( من تزكى فإنما يتزكى لنفسه)) (18 – فاطر)
و لا سبيل إلى تطهير النفس و تزكيتها إلا بإتقان العبادة و التزام الطاعات، و إطالة السجود و فعل الصالحات.
و بحكم رتبة العبودية يصبح الإنسان مستحقاً للمدد من ربه، فيمده الله بنوره و يهيئ له أسباب الخروج من ظلمته.
و ذلك هو سلوك الطريق عند الصالحين من عباد الله، بالتخلية ( تخلية النفس من الصفات المذمومة)، ثم التحلية ( تحلية القلب بالذكر و الفضائل) و التعلق و التخلق و التحقق.
و التعلق عندهم هو التعلق بالله و ترك التعلق بما سواه.
و التخلق هو محاولة التحلي بأسمائه الحسنى، الرحيم و الكريم و الودود و الرءوف و الحليم و الصبور و الشكور.. قولا و فعلا.
و التحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء و اللطف و المشاكلة، فتصبح نورانيا في طباعك أو تكاد.
و لا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة و الطاعة و العمل الصالح، و التزام المنهج القرآني و السلوك على قدم محمد العبد الكامل عليه صلوات الله و سلامه.
و الذي يعلق على هذا الكلام فيقول:
قولك عن النفس أنها (( السر )) هو كلام أغمضت فيه، و ألغزت و حجبت و ما كشفت.
أقول له إن نفساً فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج صعوداً و هبوطاً، و فيها القابلية أن تكون ربانية أو شيطانية أو حيوانية أو جمادية.
نفس بهذه الإمكانيات هي (( السر الأعظم )) ذاته.
و من ادعى أنه أدرك السر الأعظم؟!!؟ إن هي إلا أصابع تشير... و المشار إليه لا يعلمه إلا الله... و نحن جميعاً لا نعلم