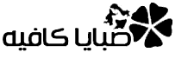الطريق إلى الله
الطريق إلى الله
لحمد لله المطَّلِع على خفايا السرائر، العالم بما في الضَّمائر, المستغني في تدبير مُلكه عن المشاور، مقلب القلوب، غَفَّار الذنوب، سِتِّير العيوب، مُفرِّج الكروب، والصَّلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، جامع شَمل الدين، وقاطع دابر المُلحدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أمَّا بعد:
فقد شُرِّف الإنسان وفُضِّل على جميع خلقِ الله باستعداده لمعرفة الله، وهذا الاستعداد هو كماله في الدُّنيا, وعُدته وذُخْره في الآخرة، ومعرفة الله تكون بالقلب لا بالجوارح، فالقلبُ هو العالم بالله, الساعي إلى الله، والجوارح هي أتباعٌ وخَدَم وآلاتٌ للقلب، والقلبُ هو المقبول عند الله إذا سَلَّم به، وهو المحجوب عن الله إذا استُغْرِق بغيره؛ (وكل إناء ينضح بما فيه)، وبإظلامه واستنارته تظهر مَحاسن الأخلاق ومساوِئُها، إذًا الطريقُ إلى الله يكون بِحُسن الخلق والبُعد عنه يكون بسوء الخلق، إذًا فما معنى الأخلاق؟
الأخلاق في اللغة: جمع "خُلُق"، وتعني العادة والسجيَّة والطبع والدين, واضحٌ من التعريف أنَّ الأخلاقَ منها ما هو فطرى، ومنها ما هو مكتسب، وأيضًا منها فضائلُ، ومنها رذائل، وفضيلةُ حسن الخلق بَيَّنها الله - تعالى - وجَمعها في رسولِه الكريم بقوله - تعالى -: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا))، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما بُعِثت لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاق))؛ الحاكم والبيهقي، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الدين حُسن الخلق))، وجاء رجل إلى رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم - وقال أوصني، فقال له - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اتَّقِ الله حيثما كنت، وأَتْبِع السيئةَ الحسنةَ تَمحُها، وخالق الناسَ بخُلُق حسن))؛ الترمذي، ولما خلق الله الإيمان، قال: اللهم قوني فقواه بحسن الخلق, والسخاء، ولما خلق الكفر، قال: اللهم قوني، فقواه بالخل وبسوء الخلق.
وواضح مما سبق أنَّ الأخلاق ليست جزءًا من الدين فحسب، إنَّما هي جوهره ورُوحه؛ لأن الدين في مضمونه عبارة عن الواجبات التي يلتزم بها الإنسانُ نحو الله، ونحو نفسه، وغيره من المخلوقات.
والسؤال الآن: هل يمكن تغيير هذه الأخلاق أو تعديلها؟
يرى أصحاب المدرسة الاجتماعية أنَّ الأخلاق لا يُمكن تغييرها ولا تعديلها، فالإنسان أسير طبيعته التي ولد بها، ولا حيلةَ له في تغيير طبيعته، لكن هذا ليس بصحيح، وإلاَّ لما كان هناك فائدة من بَعثة الأنبياء والرسل؛ لذلك قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((حسنوا أخلاقكم))؛ "أخرجه أبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق"، وحسن الخلق يكون بالمجاهدة، والرِّياضة، وحمل النفس على الأعمال الحسنة، قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، فمن أراد أن يكون جوادًا، فعليه ببذل المال والمواظبة عليه تَكلُّفًا، حتى يصير هذا طبعًا يؤديه في يُسر وسُهولة، ويصبح هذا الأمر مستلذًّا عنده، كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وجُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة))؛ أخرجه النسائي.
وجميع الأخلاق المحمودة شرعًا تحصل بهذه الطَّريقة، وهذا وإن كان في خلق البهائم ممكن؛ إذ ينتقل الكلب من شُرْه الأكل إلى التأدُّب والإمساك والتخلية، والفَرَس من الجِمَاح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق, فمن باب أولى يحصل للإنسان.
فإذا عرفنا أنَّ الأخلاقَ الحميدة يُمكن اكتسابها بالرياضة تكلفًا لتصير طبعًا, وهذا من عجب العَلاقة بين القلب والجوارح, فإنَّ كل صفة تظهر في القلب, يفيض أثرُها على الجوارح، إذًا الأخلاقُ الحسنة قد تكون بالطبع والفطرة، وقد تكون بالاعتياد وتعويد النفس عليها, وقد تكون بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم.
وإذا كان هناك عَلاقة بين القلب والجوارح، فإن كلَّ صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح، إذًا ما عَلاماتُ أمراض القلوب؟
علامات أمراض القلوب
إنَّ كل عضو من أعضاء البدن خُلِقَ لفعل خاص به، وإنَّما مرضه يكون بتعطُّل فعله، فمثلاً مرض اليد أنْ يتعذر عليها البطش، ومرض العين أنْ يتعذر عليها الإبصار, ومرض المعدة أن تسقط شهوتُها في حبِّ الخبز والماء، كذلك مرض القلب, يتعذَّر عليه العلم والحكمة والمعرفة وحُبُّ الله والتلذذ بذكره وعبادته؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، فمن عَرَف كل شيء ولم يعرف الله - عزَّ وجلَّ - فكأنَّه لم يعرف شيئًا، ومن عرف الله أحبَّه، وعلامة المحبة أنْ لا يؤثرَ الدنيا وغيرها عليه؛ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ [التوبة: 24]، إلى قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [التوبة: 24]، هذه علامات مرض القلب، ودواؤه مُخالفة الشهوات، وعلامة صحته أن لا يؤثر عليه الدُّنيا ولا غيرها من المحبوبات.
بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه:
إنَّ الله إذا أراد بعبدٍ خيرًا بَصَّره بعيوبه، فإذا عَرَف العيوبَ أمكنه العلاج، ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه، ولا يَرَى الجِذْعَ في عين نفسه، فمن أراد أن يعرفَ عيوب نفسه، فله عِدَّة طرق:
1- أنْ يجلسَ بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، فيعرفه عيوب نفسه, وطرق العلاج.
2- أن يطلب صديقًا متدينًا، فما كره من أخلاقِه وأفعاله، نبَّهه عليها، وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: رَحِم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي, وكان داود الطائي اعتزلَ الناس، فقيل له: لماذا لا تخالط الناس؟ قال: ماذا أصنع بأقوام يُخفون عني عيوبي، هذا وقد صار أبغض الخَلْق إلينا مَن ينصحنا ويعرفنا عيوبنا.
3- أنْ يستفيدَ معرفة عيوبه من ألسنةِ أعدائه؛ "فإنَّ عينَ الساخط تبدي المساوئ"، ولعلَّ انتفاعَ إنسان بعدوٍّ يذكِّره عيوبَه أكثر من انتفاعه بصديق يَمدحه ويُخفي عنه عيوبَه.
4- أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذمومًا من أخلاقهم امتنع عنه، "فالمؤمن مرآة أخيه"، قيل لعيسى: مَن أدَّبك؟ قال: ما أدبني أحد، رأيتُ جهلَ الجاهل شينًا فاجتنبته، إنَّ معظمَ أمراض القلوب وعيوب النفس مصدرها اللسان وآفاته.
ننتقل بعد ذلك لبيانِ الرذائل المهلكات التي سببها اللسان.
آفات اللسان:
اللسان من نِعَم الله العظيمة, وبالرغم من صغر جِرمه, إلا أنَّه لا يستبين الكفر من الإيمان إلا به، ولا يَكُبُّ الناسَ في النار على مناخِرِهم إلا حصائدُ ألسنتهم، ولا ينجو من شرِّ اللسان إلا مَن قيَّده بلجام الشرع، فلا يُطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة, وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، فإنَّه لا يتعب في إطلاقه، ولا مُؤنةَ في تحريكه، ولا نجاةَ من خطره إلاَّ بالصمت.
إنَّ مُعظم أمراض القلوب وعيوب النفس تأتي من اللسان, وآفات اللسان كثيرةٌ؛ لذلك سوف أُجْمل، ثُم أفصل القولَ فيها، فآفاتُ اللسان على الإجمال هي: الكلام فيما لا يعني، والخوض في الباطل، والغيبة، والمزاح، والسخرية والاستهزاء، واللعن، والكذب، والنميمة, وفضول الكلام، وتزكية النَّفس، والمراء والجدال، والخصومة، والتقعُّر في الكلام، والفحش والسب وبذاءة اللسان، وإفشاء السر، والوعد الكاذب، والكذب في القول واليمين، والمدح... إلخ.
فهذه الآفات لها حلاوة في القلب، وعليها بواعث من الطَّبع ومن الشيطان، والخائض فيها قَلَّما يقدر أن يُمسك لسانه؛ لذلك عَظُمت فضيلة الصمت.
نأتي إلى تفصيل الكلام في هذه الآفات ونأخذ منها:
أولاً: الكلام فيما لا يعنيك:
وحَدُّ الكلام فيما لا يعنيك: أنْ تتكلمَ بكلام لو سكتَّ عنه لم تأثَم، ولم تستضر به في حال ولا في مال، ومعناه أن تتكلم بكلام مُباح لا ضَرَرَ عليك فيه، ولا على مسلم، إلاَّ أنَّك تتكلم بما أنت مستغنٍ عنه، ولا حاجة بك إليه, فإنك مُضيِّعٌ زمانَك, ومُحاسَب على عمل لسانك.
ومثاله: أنْ تَجلس مع قوم، وتذكر لهم أسفارك، وما رأيت من جبال وأنهار، وما وقع فيها من وقائع، وما استحسنته وما لم تستحسنه، فهذه أمور لو سكتَّ عنها، لم تأثم ولم تستضر.
أو أن تسأل غيرك عن عبادته، فتقول له: هل أنت صائم؟ فإنْ قال: نعم، كان مُخرِجًا عبادته من السرِّ إلى العلن، فيدخل عليه الرِّياء، وإن لم يدخل عليه الرياء، خرجت عبادته من السر إلى العلن، وعبادةُ السرِّ تفضُل عبادةَ العلن بدرجات، وإن قال: لا، كان كاذبًا, وإن سكت كان مستحقرًا لك وتأذَّيت به، وإن احتال لمدافعة الجواب، افتقر إلى الجهد؛ لذلك قال لقمان الحكيم: الصمت حكمة، وقليل فاعله.
وتكمُن أسبابُ الكلام فيما لا يعني في الحرص على معرفة ما لا حاجةَ لنا به, والمباسطة في الكلام على سبيل التودُّد، أو تزكية النفس بحكايات لا فائدةَ منها، وعلاج ذلك من ناحية العلم أنْ يعلم أنَّ الموت بين يديه، وأنَّه مسؤول عن كل كلمة، وأنَّ أنفاسه رأس ماله، فلا يضيعها هباءً، فهذا خسران مبين، وعلاجه من ناحية العمل العزلة، أو أنْ يَضَع حصاةً تَحت فيه تلزمه السكوت عن بعض ما يعنيه؛ حتى يعتاد السكوتَ عما لا يعينه؛ لذلك قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا رأيتم المؤمن صَموتًا وقورًا، فادنوا منه، فإنه يُلقن الحكمة))؛ أخرجه ابن ماجه وعن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أصبح ابنُ آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكُر اللسان، وتقول: اتَّقِ الله فينا، فإنك إن اعوججت اعوججنا، وإن استقمت استقمنا))؛ متفق عليه.
ثانيًا: الخوض في الباطل:
وهو الكلام في المعاصي، كحكاية أحوال النِّساء، ومجالس الخمر، والفُسَّاق، وتنعُّم الأغنياء... إلخ، فهذه الأمور لا يَحِلُّ الخوض فيها، فهي حرام، والخوضُ في الباطل أنواعه كثيرة، ولا يُمكن حصرها؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعظمُ الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل))؛ أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني، وهذا هو قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: 45]، وقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [النساء: 140]، وكان رجل من الأنصار يَمر بمجلس لهم، فيقول لهم: توضؤوا فإنَّ بعض ما تقولون شَرٌّ من الحدث، فهذا هو الخوض في الباطل، وهو وراء ما سيأتي من النميمة والفُحش... إلخ.
ثالثًا: الغيبة:
وحكم الغيبة أنَّها مذمومة؛ لقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12]، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ المسلم على المسلم حرام: دَمُه ومَالُه وعِرْضه))؛ أخرجه مسلم، والغِيبة تتناول العِرض؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: سَمعت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَرَرت ليلةَ أسري بي على أقوامٍ يَخْمُشون وُجوهَهم بأظافيرهم، فقلت: يا جبريل، مَن هؤلاء؟ قال: الذين يَغتابون الناسَ ويقعون في أعراضهم))؛ أخرجه أبو داود.
وحَدُّ الغِيبة: أنْ تذكرَ أخاك بما يكرهُه لو بلغه، سواء ذكرته بنقصٍ في بدنه أم نسبه، أم خلقه، أم فعله، أم قوله، أم دينه، حتى في ثوبه، وداره ودابَّته، فمما يتعلق بالبدن: ذكرُك الحَوَل والعمش، والقرع، والقِصَر، أو السواد، ومما يتعلق بالنسب: كأن تقول: أبوه فاسق، هندي، خسيس إسكافي أو زبال، ومما يتعلق بالخُلُق: أن تقول: سيِّئ الخلق، بخيل، متكبر، ضعيف، متهور، ومما يتعلق بالدين: أنْ تقول: سارق، كاذب، شارب للخمر، خائن، ظالم, متهاون بالصلاة، لا يُحسن الركوع ولا السجود... إلخ، ومما يتعلق بالثوب أن تقول: واسع الكُمِّ، أو طويل الذيل، وسخ الثياب... إلخ.
والدليل على تحريم الغِيبة: إجماعُ الأمة على أنَّ مَن ذكر غيرَه بما يكرهُه، فهو مُغتاب؛ لأنه دخل فيما ذكره رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حدِّ الغِيبة، ما ذكر إن كان صادقًا، فهو مُغتابٌ عاصٍ لربِّه, وآكل لحم أخيه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هل تدرون ما الغيبة؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره)), قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقوله، قال: ((إن كان فيه ما تقوله، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بَهَتَّه))؛ رواه مسلم.
قال الحسن: ذِكْرُ الغير ثلاثة: الغِيبة، والبُهتان، والإفك، فالغِيبة: أنْ تقولَ ما في أخيك، والبُهتان: أن تقول ما ليس فيه، والإفك: أن تقول ما بَلَغَك.
بيان أن الغِيبة لا تقتصر على اللسان:
ذكر اللسان حرام؛ لأنَّ فيه تفهيمَ الغير نقصانَ أخيك وتعريفه بما يكرهُه، والتعريض كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والغمز والهمز, والكتابة, والحركة, فكلُّ هذا حرام؛ لأنه أعظم في التصوير, والتفهيم؛ قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: "دخلَتْ علينا امرأة, فلما ولَّت، أومأت بيدي أنَّها قصيرة، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اغْتَبْتِها))"؛ أخرجه ابن أبي الدنيا.
فالغِيبة: التعرُّض لشخصٍ معين إمَّا حي، وإمَّا ميت، ومنها قول بعض مَن مَرَّ بنا اليوم أو رأيناه: إذا كان المخاطَبُ يَفْهَمُ منه شخصًا مُعينًا؛ لأنَّ المحذورَ تفهيمُه، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟!))؛ أخرجه أبو داود من حديث عائشة، فكان لا يعيِّن.
ومنها الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجُّب؛ ليزيد من نشاط المغتاب، فالمستمعُ شريكُ المغتاب، كما قال رسول الله: ((المستمع أحد المغتابين))؛ أخرجه الطبراني، فالمستمع لا يخرج من إثم، إلاَّ أن ينكر بلسانه وقلبه، وإن قدر على القيام، أو قطع الكلام بكلامٍ آخر، فلم يفعل، لزمه.
وينبغي أن يعظم ذلك فيذبَّ عنه صريحًا؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ذَبَّ عن عِرْض أخيه بالغَيب، كان حقًّا على الله أن يعتقَه من النار))؛ أخرجه الطبراني.
الأسباب الباعثة على الغيبة كثيرة منها:
1- تَشَفِّي الغيظ: ويكون الحِقْد والغَضَب في هذه الحالة سببًا لذكر المساوئ.
2- أن يشعر بأن غيره سيقصده، ويُطلق لسانه فيه، فيبادره؛ ليسقط أثر شهادته.
3- أنْ يَسير في مُوافقةِ الأقران ومُجاملةِ الأصدقاء.
4- الحسد: حسد مَن يُثني عليه الناسُ ويُحبونه، فيريد زوالَ تلك النعمة.
5- تَزْجِيَةُ الوقت بالضَّحِك، فيذكرُ عيوبَ غيره.
6- السُّخرية والاستهزاء، ومَنشؤُه التكبُّر على المستهزَأ به.
7- التصنُّع والمباهاة, وهو أن يرفع نفسَه بتنقيص غيره.
أما عن علاج الغِيبة، فيتم ذلك عن طريق العلم والعمل، ومعلوم أن علاجَ كل عِلَّة بما يُضادُّ سببَها، ويتم كفُّ اللسان عن الغيبة من وجهين:
أحدهما: على الجملة، وهو أنْ يعلم تعرُّضه لسخط الله، وأنَّ الغِيبة مُحبطةٌ لحسناته يومَ القيامة، فتنقل حسناته إلى من يغتابه, فإنْ لم يكن له حسنات، نقل إليه سيئات خَصْمه، وهو مع ذلك مُتعرِّض لمقت الله، ومُشبَّهٌ عنده بآكل الميتة، والآخر: على التفصيل، وهو ينظر إلى السبب الباعث له على الغِيبة، فإنَّ علاجَ العِلَّة بقطع سببها، وقد قدَّمنا الأسباب.
1- أمَّا الغضب، فإنَّه يقول: إنْ شَفَيْتُ غضبي عليه، فلعلَّ اللهَ يُمضي غَضَبَه عليَّ؛ بسبب الغيبة التي نهاني عنها؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من كَظَم غيظًا وهو يقدر على أن يُمضيه، دعاه الله - تعالى - يومَ القيامة على رُؤوس الخلائق حتى يُخَيِّرَه في أيِّ الحور شاء))؛ أخرجه أبو داود.
2- موافقة الأقران: وذلك بأن تعلمَ أنَّ الله يغضب عليك إذا طلبتَ سخطَه في رضا المخلوقين.
3- تنزيه النفس بنسبة الخيانة إلى الغير، فتعالج بأنَّ التعرضَ لمقتِ الخالق أشدُّ مِنَ التعرُّض لمقت المخلوقين.
4- الحسد: فيعلم أنَّه قد جمع بين عذابَيْن؛ لأنَّك حسدْته على نِعْمةِ الدُّنيا، وكنت في الدنيا معذبًا بالحسد، وأضفتَ إليه عذاب الآخرة, وقد يكون حسدُك سببَ انتشارِ فَضل مَحسودك، كما قال الشاعر:
فمن قَوِيَ إيمانه بذلك، كفَّ لسانه عن الغِيبة لا محالة.
تحريم الغيبة بالقلب:
إنَّ سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما أنْ تُحدِّثَ غيرَك بلسانِك بمساوئ الغير حرام، فأَنْ تُحدِّث نفسَك، وتُسيء الظنَّ بأخيك حرامٌ عليك أيضًا، وهذا ما عقد بالقلب؛ لقوله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12]، والظنُّ هو ما تَرْكَنُ إليه النفس، ويَميل إليه القلب، أمَّا الخواطر, وحديث النفس, والشكُّ، فمَعْفُوٌّ عنه، والمنهيُّ عنه الظن، وسبب تَحريمه أنَّ أسرار القلوب لا يعلمُها إلا علاَّم الغُيُوب.
ومثال ذلك: "مَن وُجِدَ منه رائحةُ الخمر لا يَجوز أن يُحد؛ إذ يُمكن أن يكونَ قد تَمَضْمض بالخمر ومَجَّها وما شربها, أو حمل عليه قهرًا، فهذه لا محالة دلالة محتملة، فلا يَجوز تصديقها بالقلب، وإساءة الظن بالمسلم، فليس لك أنْ تعتقدَ في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعِيَانٍ لا يقبل التأويلَ؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، والناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة، ولم يَكترثوا بتناوُل أعراض الخلق.
ومن تَبِعات سوء الظنِّ: التجسُّس، فإنَّ القلب لا يقنع بالظنِّ، ويَطلُب التحقيقَ، فينشغل بالتجسس، وهو منهيٌّ عنه؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12], فالغِيبة وسوء الظن والتجسس منهيٌّ عنه في آية واحدة، ومعنى التجسس أنْ لا يترك عبادَ الله تَحت ستر الله، فيتوصل بالاطِّلاع وهتك الستر إلى كَشْفِ المستور.
أمَّا عن الأعذار المرخِّصة في الغِيبة، فيمكن إجمالها فيما يأتي:
1- التظلُّم عند القاضي؛ إذ لا يُمكنه استيفاءُ حقِّه إلا بذلك؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ لصاحب الحقِّ مقالاً))؛ متفق عليه.
2- الاستفتاء كأن يقولَ للمفتي: "ظلمني أبي، أو زوجي، فكيف طريقي في الخلاص؟ والأسلم التعريض، فيقول: ما قولك في رجلٍ ظَلَمه أبوه أو أخوه؟ ولكنَّ التعيينَ مُباحٌ بهذا القَدْر؛ لما رُوي عن هند بنت عتبة أنَّها قالت للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما يَكفيني أنا وولدي، أفآخُذ من غير عِلْمه، فقال: ((خُذي ما يَكفيكِ وولدَك بالمعروف))"؛ متَّفق عليه، فذكرتِ الشُّح والظلمَ لها ولولدها ولم يزجرها رسول الله.
3- تحذير المسلم من الشرِّ، كما في حالة الاستشارة في الزَّواج أو السُّؤال, قيل: ثلاثةٌ لا غِيبة لهم: الإمامُ الجائر، والمبتَدِع، والمجاهر بفسقه.
4- أن يكون الإنسان معروفًا بلقبٍ يُعرف عن عيبه، كالأعرج, والأعمش، ولأنَّ ذلك قد صار بحيثُ لا يكرهه صاحبُه لو علمه، وأصبح مشهورًا به.
أمَّا عن كفَّارة الغيبة، فهي أن يتوبَ ويندم ويتأسَّف على ما فعله؛ ليخرج به من حقِّ الرب، ثم يستحل المغتاب ليحله؛ ليخرج من مظلمته، والاستغفار له؛ لقول رسول الله: ((كفارة من اغتبته أن تستغفر له))؛ أخرجه ابن أبي الدنيا.
رابعًا: المزاح:
وهو مذموم ومنهي عنه، إلا قدرًا يسيرًا، والمماراة فيها إيذاء؛ لأن فيها تكذيبًا للأخ والصديق، أو تجهيلاً له، وأما المزاح ففيه انبساطٌ وطيبُ قلب، فلِمَ يَنْهى عنه؟
أمَّا المزاح المنهيُّ عنه، فيخصُّ الإفراط في المزاح والمُداومة عليه, أمَّا المداومة عليه، فلأنَّه اشتغال باللَّعب والهزل، واللعب مُباح، لكنَّ المواظبة عليه مَذمومة، وأما الإفراط: يُورث كثرة الضَّحك، وكثرةُ الضحك تُميت القلب, وتورث الضغينة, وتسقط المهابة والوقار، فما يَخلو من هذه الأمور، فلا يذم؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي لأمزح ولا أقول إلاَّ حقًّا))، وقال عمر - رضي الله عنه -: مَن كَثُرَ ضحكُه، قَلَّت هيبته, ومن مزح استُخِفَّ به، ومن أكثر من شيء عُرِفَ به، ومن كثر كلامُه، كَثُر سقطه، ونظر وهيب ابن الورد إلى قوم يضحكون في يوم عيد لهم، فقال: إنْ كان هؤلاء قد غُفِرَ لهم، فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يُغْفَر لهم، فما هذا فعل الخائفين.
فهذه آفة الضحك, والمذموم منه أنْ يستغرقَ ضحكًا، والمحمود التبسُّم الذي ينكشف فيه السن، ولا يَسمع له صوتًا؛ قال عمر - رضي الله عنه -: أتدرون لماذا سُمِّيَ المُزاحُ مُزاحًا؟ قالوا: لا, قال: لأنه أزاح صاحِبَه عن الحق، وقيل: لكلِّ شيء بذورٌ، وبذورُ العداوة المُزاح.
ومن أمثلة مُزاحه - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما رواه ابنُ عمر؛ حيث قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي لأمزحُ، ولا أقول إلا حقًّا))، فإنْ قدرت على ما قَدَر عليه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - هو وأصحابه أنْ تَمزح ولا تقول إلاَّ حقًّا، ولا تؤذي قلبًا، ولا تفرط فيه، وتقتصر عليه أحيانًا على الندور، فلا حَرجَ فيه، ومن الغَلَط أنْ يُتَّخَذَ المزاحُ حرفةً يواظَب عليها.
قال أنس - رضي الله عنه -: "كان رسولُ الله أفكهَ الناس مع نسائه"، وكان - صلَّى الله عليه وسلَّم - أكثرَ مزاحه مع النساء والصِّبيان؛ معالجة لضَعف قلوبهم من غير ميل إلى هَزل.
ورَوى أبو هريرة أنَّهم قالوا: إنك تداعبنا، فقال: ((إنِّي وإن داعبتكم لا أقول إلاَّ حقًّا))؛ أخرجه الترمذي وحسنه.
من مزاحه أيضًا: أتت إليه عجوزٌ، فقال لها - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يدخل الجنة عجوز))، فبكت، فقال لها: ((إنَّك لست بعجوز يومئذٍ؛ قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ [الواقعة: 35 - 36]، والحديث أخرجه الترمذي.
وأنَّ امرأة أخرى جاءت إلى الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا رسول الله، احملني على بعير, فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بل أحملك على ابن بعير)), فقالت: ما أصنع به، إنه لا يحملني، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما من بعير إلاَّ وهو ابن بعير))؛ أخرجه أبو داود والترمذي.
وقال أنس: كان لأبي طلحة ابنٌ يقال له: أبو عُمَير، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يأتيهم ويقول: ((يا أبا عُمَيرٍ، ما فَعَل النُّغَيْرُ؟))؛ متفق عليه، "النُّغَيْرُ": فرخ العصفور.
خامسًا: السخرية والاستهزاء:
ومعلوم أن السخرية محرمة ومنهيٌّ عنها؛ لقوله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ [الحجرات: 11].
ومعنى السُّخرية: الاستهانة, والتحقير، والتنبيه على العيوب على وجه يُضحَك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول, وقد يكون بالإشارة والإيماء إذا كان ذلك بحضرة المستهزَأ به، لم يسمَّ ذلك غِيبة وفيه معنى الغيبة؛ قال ابن عباس في قوله - تعالى -: ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: 49]: "إنَّ الصغيرة التبسُّم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك"، وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذُّنوب والكبائر، وعليه نبّه قوله - تعالى -: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: 11]، هذا يحرم في حق من يتأذى به، أمَّا من جعل نفسه مَسخرةً, وربَّما فرح من أن يُسخَر به، كانت السخرية في حقِّه من جملة المزاح.